المعرفة والاعتقاد مقاربة عبر مناهجية في أنساق الفكر الإسلامي
يتشاكل الفكر العقائدي مع سائر أشكال التفكير الأخرى بخصوص المشكلات المعرفية العامة التي تواجه أنواع النشاط الذهني كافة، ما دام حيز الفكر العقائدي هو أيضاً يتمثل الشروط المعرفية ذاتها ومنازلها في البرهانية والبيانية والعرفانية بحسب التقسيم الأثير لناقد العقل العربي محمد عابد الجابري. ما يفسر فروق التفكير العقائدي ما بين جمهور العوام وخصوص أهل الصنائع كالفلاسفة وأهل الكلام: ذلك قبل ذلك، لا بد من تسليط الضوء على ما يجب إيضاحه؛ وهو العقيدة بوصفها إحدى أبرز المشكلات في التصور الحديث للعلم والمعرفة، فلا عجب أن تساءل الغرب الكلاسيكي حول مصير فلسفته الحديثة حول مصير فلسفته الحديثة، ذلك أن أعمال أوغيست كونت لم تنجح في تغيير وجهة النظر الغربية كلياً إلى ضرب من العلموية الصلبة التي اختزلت ما يجب أن يكون عليه الفكر الإنساني في أن لا يكون أبعد من مجرد معرفة تعكس حقائق العالم الموضوعي، وقد ظنّ حتى جمهور العلمويين بعد أن الفكر يمكن تجريده من عوارض الإعتقاد، وتمكينه من مباشرة موضوعه الواقعي بإيجابية. وهذا الشطط الذي أدركت الفلسفة الغربية المعاصرة حجم الأضرار التي جلبها على العقل الإنساني في شتى تمظهرات النشاط النظري والعلمي الحديث، جعل العقيدة عدد العلم؛ فالتحقيب الكونتي للعلم يخضع لما سمّاه “قانون الحالات الثلاث”، المرحلة اللاهويتة، والمرحلة الميتافزيقية والمرحلة الوضعية، ففي المرحلة اللاهوتية، يتركز فكر الإنسان حول الأسباب المفارقة والعلل الأولى خلف الظاهرة، بحثاً عن المحرك الأول، بينما لا تختلف المرحلة الميتافيزيقية عن هذا الطرح سوى في أنها تغيّر من وجه هذا المفارق لتبحث عن أسباب أخرى غامضة ثانوية في صلب الظواهر. ويبلغ الفكر العلمي دقته وواقعيته – إن شئت القول – مع المرحلة الوضعية (الإيجابية) التي تكتفي بملاحظة العلاقات بين الظواهر وفهمها، ولا شك في أن ذلك كان منطلقاً لتعميم هذه النزعة على الثقافة العلمية والفلسفية في الغرب الحديث، وهي لحظة جعلت العصم مناهضاً للمتعقدات بما فيها الميتافزيقيا التي ألحقها كونت باللاهوت من حيث نزعتها إلى التفسير والبحث عن علل أولى لتفسير وجود الظواهر، ولكم ذاق العالم من ويلات هذا التصور الصلب؛ ولكن البنيّ في آنٍ معاً، ودائماً كان قدر الفكر الإنساني الذي لم تستطع هذه النزعة التمكن منه، أن يبتهج بقدر ما يتفهم سبب هذا التطرف في فهم العلم ووظيفته. ولعل واحداً من أوجه غباء هذه النظرة أنها سعت لإقناع أجيال من المفكرين الماديين بأنهم يدركون كيفية إشتغال الذهن البشري، ولا شيء أنكر من هذا التصور اليوم بعد الإنقلاب الكبير الذي عرفه الفكر الحديث وهو يعيد النظر في موقفه من المعتقدات وبقية القوى التي أبعدتها هذه النظرة المتعسفة إلى العلم. لقد عاش العالم على إيقاعٍ من العقلانية السخيفة التي اختزلت النشاط الذهني والإبداعي للإنسان في قوانين تفكير انقلبت عليه حصراً وإنسداداً، حيث بدت العلموية التي شكلت في فترة من الفترات موضة الفادي والبادي في المجال الغربي، أشبه بشيء من البؤس الفكري الذي أظهر كم كان الغرب الحديث في مغامرات البحث عن صيغة قتل الإله؛ جزئياً للغاية؛ لكنه سطحي حدّ البؤس، وليس أكثر سطحية من فكر أزاح المعتقد ودوره في عملية التفكير نفسها. فمحاربة المعتقدات رأساً بعد تكهّن مستقبل بشري خال في مجال المقدس والإعتقاد، بحثاً عن اليقين العلمي الإمبريقي، لا يفهم إلا إذا اعتبرنا أن العلموية نفسها ستصبح عقيدة توجه كل أشكال التفكير الماديّ خلال القرن التاسع عشر، وليس من قبيل المفارقة أن يكون داعية موت الإله نتيشه هو أكثر الفلاسفة الغربيين الذين ناهضوا طريقة التفكير الغربي وعقلانيته المفرطة، ليفتح المجال أمام سائر الأبعاد الإنسانية الأكثر إستبعاداً في منظور النزعة العقلانية والوضعانية وغيرها. وإلى هذا بات المفكر اليوم يتحدث عن تداخل العقلاني مع اللاعقلاني في عملية التفكير، وغدت مساحة الخيال الخلاق أوسع من ذي قبل، فالإنساق التي ينسجها العلم والدين جنباً إلى جنباً وفي تعايش مستمر متفاعلة في المجتمع الواحد بل داخل الذهن الواحد، لم تترك مجالاً لإستمرار فكرة طرد العقائد في مجالات الفكر العلمي. لم يعد العلم مجرد إجراءات برهانية صرفة لا دخل فيها للخيال، بل إن المعرفة هي عملية نشيطة شمولية، وهي حصيلة التصوير والذاكرة والتعقل، ضمن هذه المقاربات تأتي هذه الدراسة التي تتمحور حول ابستمولوجيا الفكر العقائدي، وموقعه في منازل العلم والمعرفة والتي عدّها الباحث ثلاثة مشاكل، الأولى تتعلق بإمكانية التأريخ للفكر العقائدي، حيث عمل على إثبات أنه تاريخ ممكن؛ لكن بشرط تغيير الفكرة حول مفهوم التقدم في عموم المعرفة كما في خصوص الإعتقاد الثانية: تتعلق بسؤال الموضوعية في الفكر العقائدي. وكانت مهمة الباحث هما إثبات أن إحراز جانب ضروري منها أمر ممكن، لكن بشرط الإعتراف بتداخل الذاتي والموضوعي، وأن هذا التداخل هو عين الموضوعية، أما المشكلة الثالثة فهي متعلق بسؤال المنهجية، وههنا كان لا بد للباحث من إثبات أن المنهجية وحدها لا تكفي، بل لا بد من شدّ عضدها بفهم يرقن بها إلى ما بعد المناهجية أي العبر مناهجية. ومن هنا، انقسمت المعالجة إلى قسمين، الأول تم تخصيصه لتناول جانب من الإجابات عن التساؤلات السابقة، وهو يعالج الجانب الإبستمولوجي للعقدة، وثم تخصص القسم الثاني للمعالجة التطبيقية على أنساق التفكير العقائدي الإسلامي. نرى وجود ثلاث مشكلات تتعلَق بابستيمولوجيا الفكر العقائدي، وموقعه في منازل العلم والمعرفة؛ الأولى: تتعلَق بإمكانية التأريخ للفكر العقائدي. زسنعمل على إثبات أنه تأريخ ممكن، لكن بشرط تغيير فكرتنا عم مفهوم التقدُم في عموم المعرفة كما في خصوص الإعتقاد؛ الثانية: تتعلَق بسؤال الموضوعية في الفكر العقائدي. وسنعمل على إثبات أنَ إحراز جانب ضروري منها، أمر ممكن؛ لكن بشرط الإعتراف بتداخل الذاتي والموضوعي، وأن هذا التداخل هو عين الموضوعية المتاحة، والثالثة: تتعلَق بسؤال المنهجية. وسنهمل على إثبات أن المهجية وحدها لا تكفي، بل لا بدَ من شدعضدها بفهم يرقى بها إلى ما بعد المنهاهجية. أي إلى العبر- مناهجية. ومن هنا تنقسم هذه المعالجة إلى قسمين. خصَصنا الأوَل منهما لتقديم الجواب عن الأشئلة المشار إليها أعلاه، ووقفنا الثاني على المعالجة التطبيقيَة لإنساق التفكير العقديّ في الإطار الإسلاميّ.
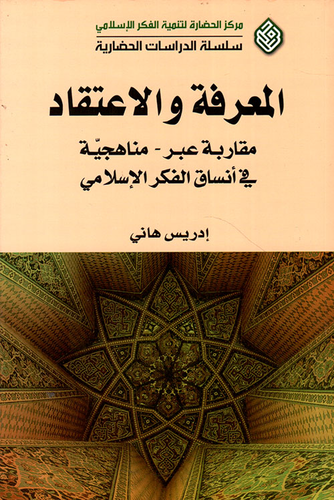
اشتراک گذاری
/